الجزء الأول –
مرت سنة على انفصالنا الافتراضي، بكيت عليك ما بكيت و فرحت بعدك بما فرحت. بردت لوعة الألم بعد انقضاء عمر صلاحيته الافتراضي، و هو شهران… فهدأت أوراق الأشجار و خفضت رأسها أعمدة الإنارة التي كانت تسهر من أجلنا، لأنها ملت القبل الاصطناعية و الرسائل الإلكترونية الجامدة و مضاجعات القبو بعد منتصف الليل و قنينات البيرة الرخيصة المرمية بإهمال و تعب بقربها…
ماذا سيحرس عمود نور في قنينة بيرة فارغة؟
لهذا عشقتنا الشوارع والأطفال و أعمدة الإنارة… خيل لها أنها وجدت شيئا يستحق أن يحرس… حرست وشوشاتنا تحت نجوم الليل و نور القمر المفتخر بنا… كان القمر مزهوا بنا! مزهوا بحلم عاشقين يخبئان في جسدهما النحيل أحلاما أكبر من مصروف جيبهما، – لم أكن أحب طلب أشياء مادية منك لأنني كنت أخشى عليك… خشيت عليك من وصمة الماضي… خشيت أن تتزوج و تنجب أطفالك و تخبرهم أنك يوما ما أحببت فتاة و طلبت منك الجلوس في مقهى أو شراء “آيس كريم” لكنك لم تكن تملك ثمنه…- و أضخم من الصناديق التي سجنا بداخلها، عاشقين واجها شمط الحياة بالحلوى و قطع السكاكر… و ريشة طاووس و قلادة حب و هدية عيد ميلاد و رسالة حب… رشونا الحياة بكل ما نملك فخرجنا منها مفلسين كريهين…
التحقت بالمعهد العالي للموسيقى و الرقص، و ظللت أبحث عن سبب التحاقي هذا… هل هو تخليد لك من خلال رقصة كره و رقصة عداء! أم أن جسدي ضاق درعا بي فقرر أن يخرج أعضاءه من كأس خمرك التي اختمرت بداخلها حد النخاع؟
لا أعلم… و لن أعلم أبدا…
صارت ساحتي خاوية من الجميع… فالسنة التي أمضيتها بعدك علمتني أن فيضان الحب الذي بداخلي لم ينضب و لم يجف، فقط خيل لي ذلك عندما جفت أنهاري حين وجهتها نحوك لكن ما زال باستطاعتي أن أحب و أعشق و أهتم و هذا من أهم اكتشافاتي بعدك و أثمنها على الإطلاق، الفرق الوحيد هو أنني أستحيل صحراء قاحلة و أنا بصحبتك و أتحول إلى واحة خصبة مع كل من سواك، فتحولت إلى ملجأ من طلبني للعطف أو النصيحة أو المواساة أو التفهم… مازحني صديقي كيف تمنح امرأة نصائح حب و هي دون حبيب فأجبته أن العيب ليس بحبي و إنما بوجهة حبي، تماما كالأراضي غير القابلة للزراعة؛ لا يهم كم من الماء سقيتها و كم من البذور منحتها فأنت تعرف أن جهودك عديمة الفائدة لأنها لن ترد لك الجميل سوى قحولا و جفافا. كان علي أن أتعلم فن التفريق بين الأراضي القابلة للزراعة و تلك غير القابلة لها.
قدر الإنسان أن يدفن هو و خيره تحت التراب… تماما كما دفنت كل ما فعلته لأجلك تحت التراب… ربما كان القرض الذي أخذته من الحياة… من أجل تغطية نفقاتك… بالغ الغلاء… و خيل لي يوما ما أنني سأمضي الأبدية معك… لا أنكر أنني أردت لحبنا شراسة و قوة قصص حب الزمن الجميل، حيث الحبيبة تظل بجانب حبيبها مهما كانت الظروف، و إنني قد فعلت… أردت لقصتنا عبارة “نهاية” و موسيقى انتصارية و عناقا يجمعنا تحديا لكل الصعاب… و لا يؤسفني شيء بقدر أن تثير بقايا وجهك بذاكرتي شعورا مستثرا بالغثيان… جاهدت نفسي كي لا أصل إلى مرحلة اللاعودة… حيث يصير اسمك مكسوا بالوحل و الديدان و رائحة تعبق بموت عفن و قبلاتك جثث متحللة تستعد للدفن… و أخيرا بلغت مرحلتي هذه، راهنت نفسي أنني سأكرهك عما قريب… و كم وددت لو أن أخسر رهاني هذا كما خسرت رهاني ضد كل من سواك… لكنني هذه المرة راهنت نفسي! فهنيئا لي بفوز الرهان…
قاعة الرقص صامتة و خاوية… و البلاط الخشبي الملمع و المرآة الحائطية أصبحا مشروعي منذ فراقك… إنها حصص ترويض، ذلك أنه يحدث كثيرا أن يخسر الجسد مهاراته الأساسية حزنا و شجنا… فأردت أن أعلم رجلاي كيف تجريان من أجل أمر غير لقائك و تقفزان على شيء غير جثتك و علمت ذراعي أن تتحررا من التلويح لك و علمت خصري أن يلاعب عمود الرقص بدل من أن يلاعبك و علمت وجهي أن يبتسم و يشرق لشيء غير حضورك و علمت حاجباي أن يرتفعا فخرا و اعتزازا عوض مكابرة و معاندة…
إنها امتحانات منتصف السنة و المطلوب اختيار موضوع معين و تصميم choreography تليق به مع مراعاة الأزياء و الموسيقى المختارة.
كانت المشرفة على مشروعي سيدة فرنسية، تحمل في قسمات وجهها الهادئة صخبا انتهى رماداً و عيناها… يختبئ بداخل لونهما الذهبي طيف أمي الجميل… لم أفهم أبدا لم تذكرني السيدة “” sophie بأمي… ذلك الهدوء الملائكي… تلك الرزانة التي تخبئ وراءها امرأة تجلس كل مساء على كرسيها الخشبي الهزاز ممسكة بذلك الكتاب القديم متأملة الغبار المتراكم الذي ينسحب بنفحة واحدة من أنفاسها… و تطمئن على وردتها الحمراء الذابلة… ما زالت حمراء و ما زالت ذابلة… كلنا نحمل وردة حمراء ذابلة نعيش من أجلها رغم أنها ماتت منذ زمن طويل.
كنت المفضلة لديها من بين كل الطلبة، أخبرتني يوما أنها ترمق في عيناي تحديا دائما و حربا مستترة كأنما هناك شيئ يحاول تسلقي نحو الأفق… “ما الذي تتحدينه…؟” جاء سؤالها متأملا مباغتا و فضوليا… جاءت إجابتي أصعب من السؤال فابتسمت مجيبة إياها: ” إنني أتحدى قدري يا سيدتي”…” و هل نجحت في ذلك؟ “… الحقيقة أننا نعلِّم رزمانة أيامنا بتطور مشاعرنا على مر الزمان، نحن لا نهتم ليوم اثنين لأنه يوم اثنين بل نهتم به للمشاعر التي أحطناها بقلم أحمر فوق صفحة أجندتنا، و هذا اليوم بالذات لم يكن لدي مزاج للصراحة… لم يكن يوما مناسبا لممارسة الصراحة، بكل بساطة، لذا استأذنتها مبتسمة و خرجت من الفصل.
وجدت مشرفتي اختياري للأغاني غريبا و “أكثر جرأة” من لافتة “المعهد العالي” المعلقة خارجا، و بغرض نبش سبب هذا الاختيار طلبت مني الانضمام إليها في حديقة منزلها لشرب الشاي و الدردشة قليلا بعد انتهاء حصة الرقص التعبيري. استأذنتها في طلب انضمام أمي
إلى جلستنا لأنني أكره تركها وحيدة و قد تحتاج مساعدتي في أمر ما، أشرق وجهها لطلبي هذا ثم مررت على أمي كي أقلها…
“تشبهين أمك كثيرا… “. ابتسمت نصف ابتسامة مثقلة بذكريات كثيرة و ضخمة…” أخبريني ما سر تعلقك الشديد بها؟ “. سرحت في حديقتها صامتة محتضنة كوب الشاي، لم يخرجني من كوخ ذاكرتي سوى صوتها ينادي إسمي في قلق حرج :” هل أزعجك سؤالي عزيزتي؟ “. ابتسمت لها نفيا ثم بعد ثوان سألتها:
-سيدة صوفي… ما هي القاعدة الأساسية التي يجب أن يتبعها المتبرع بالأعضاء قبل أن يقرر التبرع بها لمريض في حاجة؟
-(بكثير من الاستغراب)… أن يتبرع بالعضو دون تعريض حياته للخطر!
-و ماذا لو اكتشفت أنك قد أصبت بمرض خبيث يتطلب منك استئصال عضو من أعضائك، و وجدت متبرعا متطوعا… كيف سيكون شعورك كينها؟
– حسنا… أظن أنني سأشعر بارتياح كبير كوني أملك فرصة لإنقاذ حياتي… بل سأكون مدينة لذلك المتبرع بحياتي.
وضعت كوب الشاي فوق الطاولة بهدوء و اعتدلت في جلستي ململمة كلماتي في رأسي كمن يعلم أنه لن ينبت ببنت شفة بعدها:
-“إن التشبت بشخص ما ليس اختيارا، بل هو ضرورة، ذلك العضو الجديد سيمضي فترة ليتأقلم فيها مع دماء جديدة و أعصاب جديدة
و أعضائك الأخرى و سيتشبت بك و تتشبتين به أيضا، لأن حياتك بأكملها تعتمد على وجود ذلك العضو بالذات. أما فيما يتعلق بأمي، فهي قد سخرت راحة رحمها لكي يتحمل عبثي لمدة ٩ أشهر، و تحمل نهدها ألم جوعي و نهمي، و حين كبرت تحمل قلبها ألمي و من ثم لعق لسانها دمعي كي لا أتذوقه يوما. إن كنت تدينين بحياتك لشخص منحك عضوا واحدا من أعضائه و ظل على قيد الحياة، فما الذي علي أن أدين به لامرأة لم تمنحني عضوها فقط، بل انتشلت من نفسها كل الحياة كي تمنحني إياها؟.
اسأذنتها وسط شدوهها و توجهت جريا نحو أمي داعية إياها للانضمام إلى جلستنا… جميلة هي أمي، لم تزدها خصلات شعرها الذهبية و الفضية سوى جاذبية من زمن الأحلام، ما زالت طفلة تسعدها بتلات الورود و تبارك صباحها فرحا بقدوم فراشة تائهة…
-“تعالي يا أمي انضمي إلينا… ”
-” لا بأس صغيرتي، اتركيني هنا لقد وقعت في حب هذه الحديقة… تعلمين أنت كم أحب الورود “
قالتها بهدوء أخافني و أفزعني من حيث لا أعلم! أكثر ما يخيفني في الأشخاص هدوءهم! توسلتها كي تظل بجانبي و أحتمي بكتفها و عطر جسدها… لا أعلم هل رأت في عيناي ما خشيت إخبارها به أم أنها استسلمت أمام صغيرتها اللحوحة فقط… لا يهم، الأهم أنني ما زلت أشتم عطرها.
غادة الحجاجي
كاتبة من المغرب





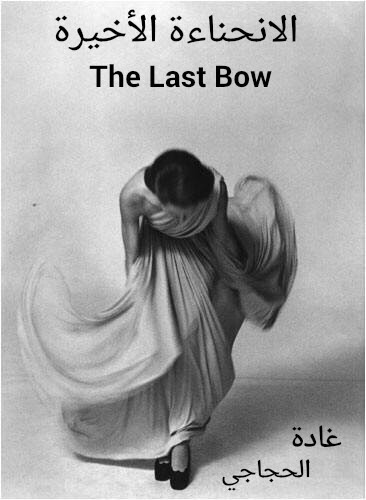





السن الذهبية / ادريس خالي
نصوص / تغريد عبد العال
مختارات من “ومخالب إذا لزم الأمر” / خالد أبو بكر