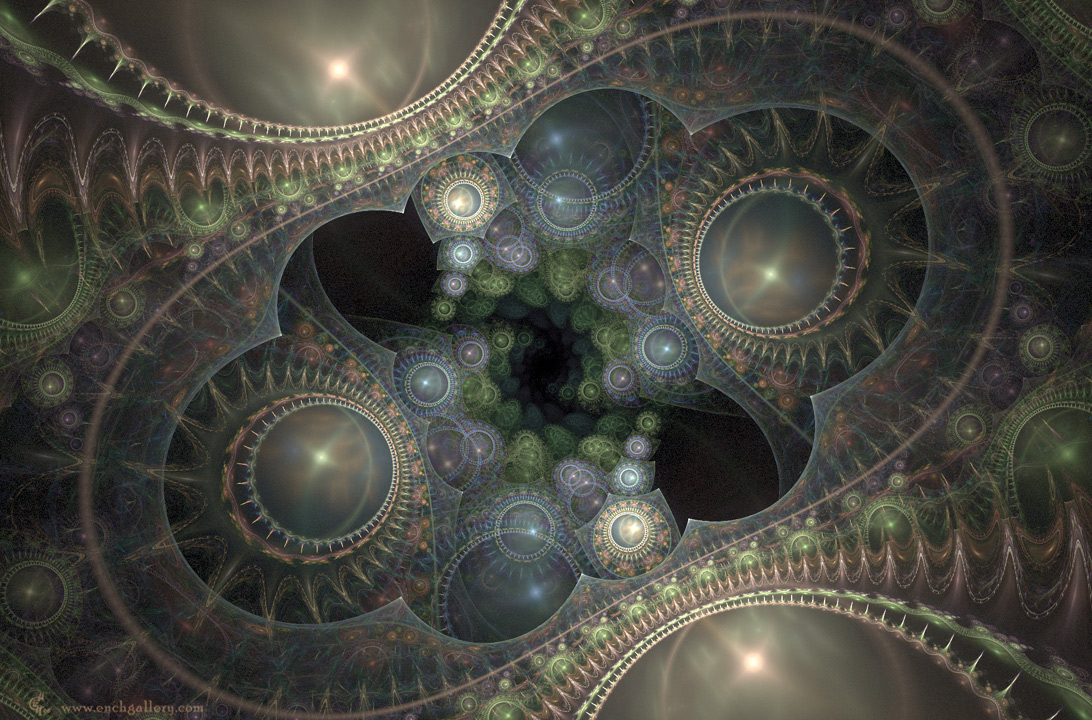 المقولة كينونة تكاد تستقل عن كاشفها، دالّةٌ تبسطها الإشارات وتسطرها الحروف، فيها السّاحر ومنها المسحور، وقد لا تدلّ على أيّ شيء أبداً. فالأبجدية مخلوق مارق، نُحاربه فيهادننا، ونَخضع له فيفتِك بنا، دون استجلاء الأسباب؛ والسّين بيتٌ لا باب له، سَمِخٌ واثقٌ סּ، مخروم المزلاج وثوراه هائجان يجريان بثبات. إنّه حرف يستبدّ، وقد يسكر ويسمر، ليُسلسِل المعاني. يسكن الفعل المضارع ويوثق الوسط بإحكام كي يفتحه على الرّقص: هذه «الحركة» التي، بسبب «تحريمها»، يتراجع «التّفكير» في الصناعات الجمالية لصالح المواقف السياسية المحضة. ومع ذلك، يبقى هنالك «سطح مشترك» تتقاتل فوقه كتائب النّسخ وتمثّلات المطلق وفجوات الغياب الإلهي. من أين يتسرّب هذا المارد الألفبائي إلى اللّغة والشّعر والخرائط، نحو آثار الفكر والصيغ التصويرية الحديثة (الإملاء والمُنشأة والفيديو) وتاريخ السياسة المحكية والمُزمّمة؟ وكيف يتكوّن الأثير الخفيف الذي يتحوّل عبره نقشٌ لفظيّ إلى حاكميّة مخطوطة؟
المقولة كينونة تكاد تستقل عن كاشفها، دالّةٌ تبسطها الإشارات وتسطرها الحروف، فيها السّاحر ومنها المسحور، وقد لا تدلّ على أيّ شيء أبداً. فالأبجدية مخلوق مارق، نُحاربه فيهادننا، ونَخضع له فيفتِك بنا، دون استجلاء الأسباب؛ والسّين بيتٌ لا باب له، سَمِخٌ واثقٌ סּ، مخروم المزلاج وثوراه هائجان يجريان بثبات. إنّه حرف يستبدّ، وقد يسكر ويسمر، ليُسلسِل المعاني. يسكن الفعل المضارع ويوثق الوسط بإحكام كي يفتحه على الرّقص: هذه «الحركة» التي، بسبب «تحريمها»، يتراجع «التّفكير» في الصناعات الجمالية لصالح المواقف السياسية المحضة. ومع ذلك، يبقى هنالك «سطح مشترك» تتقاتل فوقه كتائب النّسخ وتمثّلات المطلق وفجوات الغياب الإلهي. من أين يتسرّب هذا المارد الألفبائي إلى اللّغة والشّعر والخرائط، نحو آثار الفكر والصيغ التصويرية الحديثة (الإملاء والمُنشأة والفيديو) وتاريخ السياسة المحكية والمُزمّمة؟ وكيف يتكوّن الأثير الخفيف الذي يتحوّل عبره نقشٌ لفظيّ إلى حاكميّة مخطوطة؟
إنّ «الأسلوب» أصل من الأصول المُنبثقة عن جذر س ل ب، لا باعتباره لفظاً عربيّاً مجرّداً يعني سبيلاً للعيش تارة وفناً للحديث تارة أخرى، وإنّما مصدرا لهذا الفعل الثلاثي المتعدّ، في تجاوزه السّلب والإيجاب أو النّفي والإثبات، من حيث استقلاله وحياده، كمعناه، والسَّلَبُوتُ فعلوت منه. وسالب الشّيء فاقد القبل ومُكتسب البَعد، ومعيده إلى وضعه البدئي: سالب السّلطة مُفرغها وسالب الشّجرة جانيها وسالب اللّغة مُعرّيها. في هذا السّياق، لا يكون الأسلوب أسلوباً، في طرائق الكَلِم والتّصوير، إلاّ إذا أفصح عن نفسه آتياً من اللّغة المستحيلة لا من اللّغو الحكائي، بمعنى قدرته على إنطاق الشّواهد التأويلية الصّامتة وإخراس أبواق السّرد اليتيم. إذ ثمّة تماسٌّ فعليٌّ هنا بين تبدّي الأشكال وتطوّرها، بصورة خفيّة ومسقلّة، وبين انتزاعها من نفسها «تجميلاً» للوقائع على نحو فضائحي.
كلّما فكّرت في الغزل مثلا، لغرضٍ لاتينيّ نزق، أتتني أشباح تلك “الأساليب” الرومانية التي كانت تُصنع من العظام والمعادن وتستعمل في الكتابة الدّقيقة؛ فالأسلوب مطابق للأشياء القويّة والخفيفة، للنّحافة والرقة، مثل سكاكين الذّبح الإبراهيمي وإبر الوخز الصّيني، مع أنّ البديع بالزاكْ كان صاحب سُمنة طافحة. يتشكّل الأسلوب إذن قبيل الإعلان عن القول الأخير، أو ما قبل الأخير، أي في اللّحظة التي يخرج فيها الكائن-السّلبوت عن صمته، ليصرّح للعالم، بالشّعر أو بغيره. والشّعر لا يقول الحقّ وغيره يجانب الصواب والمنايا واقعة. هل يقلّد الشّعر الحقيقة، الكاملة والتامة، أم يكرّرها تحصيلا للحاصل، أم أنّه مُؤْيِسُ الأيسات عن ليس فيها؟
«الإملاء» ضربٌ من الشّعر، كأنْ تنطق الكلام بصوت عالٍ، داخليّا ومهما اشتدّ الخوف. وأنْ تتأنّى إنْ اقتضى الأمر، أو أنْ تتهجي بيقين المتردّد يرى العصا مُلوّحةً في فضاء الفصل، وهي تشير إلى شكل السّين. يقول المدرّس: قل ومت. وأنت صغير، والأطفال في سنّك يفكّرون في الحلوى، وأنت الآن في السم. مولود جديد مستعد للموت، كما يقول دو مونتين. من الممكن أن تكبر، فلا تبقى مُستملياً فحسب، وأن يَقِرّ في قلبك ما تهمّ بقوله، شارعاً الفتحة على المُبهم الحقيقي فيك، كما فعل سركون بولص: “إذا لم تفتح الكُوّة/لن تطير إلى غرفتك الحمامة”. عنوان القصيدة الكُوّة عينها، الشّرخ الواعي والمشروط بالانفتاح أكثر على الدّاخل النصي. والفرَج، بين إذا ولن، محكوم بتقيّح اللّسان حتّى العفن أثناء رحلة المُملِي المريرة. في أبيات بولص الموالية دفع بالصّنعة إلى تخوم متقدّمة من تقانة الفكر الشّعري تحاكي عناصر النّداء والاستقبال في ميتافيزيقا الحنفاء مذ ركَل إسماعيل الأرض في عرض الصّحراء. “الماءُ يجهل أسباب الظّمأ الأخير، والأرض/تتشقّقُ رغم البراهين الدّامغة على وفرة الماء./الصّمت لن ينفتح كالصَّدَفة/إذا لم تعرف كيف تولد الوردة أو تموت”. لا يكتفي بولص بالدّخول في إملاء غنائي، بل يُنشد الحقيقة ويَنشُدها من خلال التّفكير في وجه وروح النّثر كما لو كانا معاً لقاء بُراق سماوي مع سلبوت طيني فوق غمامة ليل القيامة. “قلمٌ على المائدة، دفترٌ كمروحة الغيشا/يرفرف في خيال الورّاق/القصيدة قد تضيع، إذا لم تجد الخيط الخفيّ./والرّاوي لن يعرف القصّة”. تذكّروا معي من باب الاستئناس أنّ السّفر الوحيد، الأعظم والأصيل، المُتبقي من الأسطورة المحمدية، هو ارتقاء النبي إلى سِدرة المنتهى؛ ابتعاده عن واقع العرب لتلميعه بالحكمة (الحقّ) والموعظة الحسنة (الشّعر).
«المُنشأة» شعرٌ مدنيٌّ أو حربيٌّ يحتمي به الكائن-السّلبوت من أعراض الفناء الحداثي القادم، كأنْ تدهسك مخلوقات آليّة جائعة عند مدخل السّوق الكبير. وهذا ما يفعله الفنان المعاصر محمّد فتّاكة، أقصد الاحتماء من الآتي، حينما يُصمّم، بتواطئ مع حدّاد فرنسي من أصول إسبانية، درع مُحارب ينتصب فارغاً وسط الفضاء ليدخل به مرحلة الـ”سّجال الحاسم”، وهو محسوم מחסום في حقيقة الأمر. أي حاجزٌ يقطع به الطّريق على الإملاء، بالشّعر المُصفّح، مثل صومعة واقفة حين الفجر، تؤذّن لامّحاء النّهار. فلا أناشيد من شأن المرتعدين تلاوتها أمام وحش فولاذي يرفض الإقامة في المتاحف ليلتقط معه الغاوون، المفتونون بالكلام المغشوش، صورا للذكرى. يتّسم هذا العمل بأصالة وأولويّة ذاتيّتين، ومثله عمل آخر قيد الإعداد لفتّاكة، يتوزّع فيه اللاّعبون على رقعة “بابي-فُوتْ” لكنّ أحداً لا يقدر على تحريكهم، حتّى الله، مع أنّه الوحيد القادر على اللّعب بحِرفيّة الحاذقين، “ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”، وذلك لأنّ المقابض نسيتُ إنْ كانت معطّلة أم مغلّفة بمسامير صدئة. وكذلك الشّعر موجود في «الفيديو»، نراه في السّينما وفي تركيبات بعض الفنانين والسياسيين. خطاب بوش، بعد تفجيرات مانهاتن، أشبه بشِعرٍ مُصوَّر أسّس لبروباغندا ناعمة: رجل داخل مكتبة خاصّة، يرتجل كلاما حزينا، أقرب ما يكون إلى نصوص شعراء الكارثة. تحدّث عن خراب المعمار وعن المأساة والدم، برصانة مُخرج مُحنّك، مُقتبِساً الآية الثالثة والعشرين من التّوراة. كان على الجميع انتظار البيان التّالي، خطاب العشرين من شتنبر، لإشاعة لُثغة قاف “القاعدة” في التداول الأنغلوسكسوني والتبشير بأنوار مهولة أعمت بغداد، في عزّ غسق الرّبيع، سنتين بعد ذلك.
يتوغّل الأسلوب في مَجال السياسي عبر قدرته على استئصال وإيصال كينونة المقولة الأولى والأخيرة، وما بينهما، من داخل أرشيف الخسائر والانتصارات وصناديق الاقتراع الفارغة والممتلئة وصالونات البيع والشّراء السّيادية، إلى صُلب طوبولوجيا المخفي في المجال العام. لنأخذ نموذج بُقعة متوسطية متنازع عليها تاريخيّا، يحكمها الإسبان ويقول المغاربة أنّها سليبة. سبتة، تلالُ الإخوة السّبعة كما سمّاها الإغريق، والجغرافيا التي تُطوّق الخرافة لتروي قصصا أخرى. نشرت مجلّة “دعوة الحق”، المؤسّسة سنة 1957، في عددها الـ27 وثيقة تعرّضت لتاريخ المدينة في القديم والحديث، وتناولت وصف الفقهاء لها بالشّعر قبل “السّقوط”، وبعده بالنّثر. واللاّفت للانتباه بين كومة أحداث كثيفة، بدايةً بالغزو الإسلامي 709م وانتهاءً بتوقيع معاهدة 1889م، عُدول المملكة الإسبانية عن عُرف حدودي يقضي بإقامة مراكز العَسَّة على شكل أكواخ الرّيف الخشبية. مما أثار غضب قبيلة أنجرة الجبلية، ودفعها لمهاجمة البنايات الجديدة المُشيّدة من الحجارة والحديد وتلويث علم إسبانيا وشارة الحرس (شرطة عسكرية تُعرف بالـ”بينيميريتا”). لم تخضع هذه القبيلة، حسب عدد من الأنثربولوجيين، للسّلطة المركزية كما أنّها لم تتمرّد عليها. وتتحدّث مصادر استعمارية فرنسية، في مرحلة لاحقة، عن “عشق” الأنجريين للحرب وعن عدائيتهم اتجاه الإيبيريين. لكن الأجدر بالبحث، بعيدا عن «تاريخ المؤرّخين»، تزامن هذا التمرد تقريبا مع تأسيس الحرس المدني عام 1844. أستفسر اختصارا، لضيق حيّز الإيغال، عن كواليس صُلح تطوان: هل سُلّمت سبتة ومعها أعناق الأنجريين خوفا من استقوائهم؟ من سلب شرف “السّيف وشاقور الحطب”، اللذين يمثّلان شعار الـ”بينيميريتا” –قابضة الضّرائب وحامية حدود الجار العدُو-، أليس بقادر على ذبح الأسدين اللذين يحميان عرش السّلطان في مكناس؟ أسئلة قد نجد لها جوابا في غنائيات قبائل الشّمال، بين شلحة الأمازيغ وهلالية العرب، فضياع الأرض يبدأ بالتوقف عن الشّدو.
الأثير الخفيف هو إرادة كلّ من وما لا يتوقف عن الامتداد في الوجود، بالتصريح أو بالمناجاة. الزهور والقلوب لا تعلم أنّ السّير بلا رهبة يحمي من الهزيمة، في القصيد المنثور والعراك المغدور حدّ السّواء. لكنّها ماشية لأنّ طريق الزّحف أوثق، كما ورد في المُقدّمة. يحمل الأثير الخفيف اللّغة الواعية إلى الشّعر ويُلقيها للعالم، ولا سلطة للتقنية الموازية عليه، أكانت قيادة سياسية أم قوّة سِبرانية. وما دام مجازفاً فإنّه لا يتهاوى، ثقيلاً وبطيئاً كتنّينٍ مُزَوَّرٍ ينفث الرّماد، عند عتبة الإدراك الخالص.
والأسلوب أدغال الأثير المفضّلة، خفيف لا يخاف، لأنّه شرنقة الكائن-السّلبوت وصدى الحقيقة في غياباته. عُرف عن سفيان بن عُيينة، وقد كان من كبار المحدّثين، أنّه أوتي فهم القرآن ثم سُلِبَه بعدما قَبِلَ صُرّةً من أبي جعفر. تورّط الرجل في خِرقة جلديّة قدّها قدُّ الفولة وسرّها سرّ الغولة. ما كان في تلك الصُرّة يا تُرى؟
أيوب المزين : كاتب من المغرب





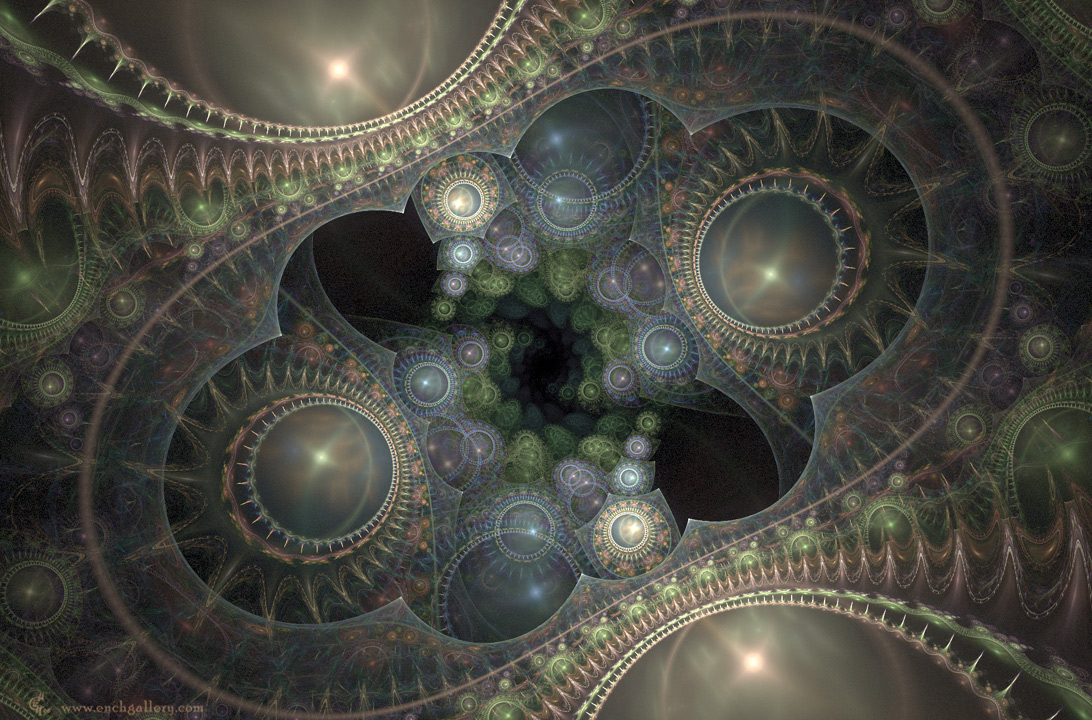




عندما يفكر الأدب / آلان باديو
مدارات ادونيس – الحقيقة طريق، سؤال متواصل
الكاتب والمحَرَّم – مع ناصر الظفيري