شعر سعدي يوسف له نكهةُ الطازج والنديّ، لكأنهَ أقربَ إلى طلوع الصباح وتفتحّ الليل، فأوقاته الفجر والغسق. ولعلّ مردّ هذا طبيعة الشاعر نفسه: فهو جوّاب الآفاق بامتياز، والصياد الماهر لجماليات الطبيعة أنّى وُجدتْ، والعاشق المرح ولكن المتخفّف من أبجديات العشق اليومي البليد. وأكثر من هذا، سعدي أستاذٌ قديرٌ في وضع رأيه السياسي بطريقةٍ خاصّة في القصيدة؛ طريقة لا يمكنُ النقد أن يصنفها، إذ هي مخاتلة؛ تتسرّب كما لو أنها «غير مباشرة»، لكنها لا تلبث أن تتضحّ بصورة «مباشرةً».
والكتاب الأخير «أنا برليني؟ بانوراما» الصادر حديثاً عن دار التكوين في دمشق، يشهدُ – ولو جزئياً – على طبيعة الشاعر، فـ «جغرافيا القصائد والنصوص» – إن صحّ التعبير-، لا تكتفي ببرلين مطلقاً، (مكان كتابة القصائد والنصوص النثرية)، ولا يأسرها العنوان وإن كان يحيلُ إلى مكانٍ بعينه : الهند، الفليبين، سيدي بلعباس، عدن… والطبيعة رفيقة سعدي أنّى وُجدت، تنبثق في القصائد كما في النصوص من خلال ثنائية : الشجر والماء. فمن أوّلها ؛ «الداليةٌ تعرّش، مثقلةً بالعناقيد. والمزارع الصغيرة تعلنُ عن النبيذ الجديد». أو «وفي خيط القميص يطول لبلابٌ وتولدُ زهرةٌ من غصن دفلى». أو «ها هي ذي رادسُ الغابة، ملتفةٌ بأشجارها وظلالها العميقة. نوافذها تكاد تخفى من متعرّشٍ ومتسلّقٍ. خضرةٌ ذات أفواف وتدرّجات وندى». ومن ثانيها ، «أمرُّ بجدولٍ أخضر الماء، جدولٍ ذي أشناتٍ وعشبٍ». أو «ثم اتّركتُ حديثها يبقبعُ بالماء». أو «يأتي وابلٌ هطِلٌ/ ويشرب النيتُ أمواهاً مقدّسةً». أمّا سعدي العاشق، فنوّاسيٌ بامتياز : «نشّفتُ جسمها اللذيذ/ وقلتُ استمتعي، بنعومة الحرير!/ لقد أغمضتِ عينيكِ فاذهبي إلى الحلم/ إني رهن حلمك».
أمّا «السياسة»- والتعبير غير دقيق – فحاضرة في الكتاب شعراً ونثراً. فمن الأوّل : «سوف نأخذُ عالم التجّار من أذنيّه/ ثانيةً./ نمرّغه بأوحال الدراهم». أو «سيأتي الأتراك بما زرعوا/ وسيأتي أكراد الأتراك بما صنع الأتراك» أو «نقولُ: العروبةُ أعمقُ/ خطّ لها مُسْنَدٌ/ وبراكين فيها/ وحريةُ امرأة، واشتراكيةٌ/ وأغانٍ/ وكانت بها حضرموتُ الفريدةُ/ حيثُ المنازل من امرئ القيس حتّى القمر/ أين نمضي، إذاً بعد أن بعُدتْ عدنٌ؟/ أين نمضي؟». ومن الثاني : «تغيّرت ملامحها فجأةً: تسقطُ فنزويلا! شافيز شيوعيّ» أو « في التكيّة النقشبندية، تهجينا الحروف الأولى من شيوعية عجيبة، ملأى بالأساطير عن عمّالٍ يبنون بلداً، وجيشٍ أحمر لا يُقهر».
وصحيح أن الأمثلة أعلاه تنضح مباشرةً برأيٍ سياسيٍ واضح، إلا أن السياق الذي ترد فيه، لا يمهد لذلك البتة، فالمرأة التي تُسقطِ بلداً برّمته لأنها ضدّ حاكمه، فنزويلية صادفها الشاعر في البيسترو. والتكية لا توحي قطعاً بأنها مكان مناسبٌ للإعجاب بالشيوعيّة. وكذا الأمرُ في القصائد. فمديحُ عدن بدأ هكذا : «إن تكن عدنٌ مثلَ قال عنها المغني أبو بكرٍ،/ الأوجَ» ووصل إلى امرئ القيس.
أمّا عالم التجّار فقد اقتحم الفجر المتشرّب بالاستعارات : «في الفجر/ عند الفجر/ نترك عتمة الحانات. آخر شمعةٍ في حانة «المستقبل»/ انطفأت….». ولعلّ هذا ما يمنع وضع القصائد أو النصوص تحت يافطة الشعر السياسيّ. إذ إن الرأي السياسي للشاعر – والتعبير غير دقيق ثانية ً- لا يبدو مقصداً بذاته، على رغم أنه الحامل الأساس للمعنى العامّ لهذا الكتاب.
مآل العالم
النصوص والقصائد يحفّ بها نقدٌ لاذعٌ لمآل العالم المعاصر، من خلال تقنيتين، تظهرُ الأولى من خلالِ الانتقال السريع بين الشرق والغرب: بادية السماوة وبقيع والدامور واللاذقية وسيدي بلعباس وتونس، من جهة، وبرلين ولندن ونيويورك، وباريس وروما من جهة أخرى. انتقالٌ مباغتٌ تحمله المقارنة تارةً: «وأنا أعبر الجسر، هنا، (في بلدة صينية) أحسستُ بما يشبه العبور من الرصافة إلى الكرخ»، والمفارقة تارةً أخرى: «لا أدري كيف شبّهت الحيّ (هارلم) بمدينة الثورة في بغداد». أمّا التقنية الثانية، فتركيبُ استعارة من المُشَاهَد المحسوس، حيثُ يبدأ سعدي كتابهُ هذا بقصيدة «حكايات البحّارة الغرباء»، الذين هبطوا «منذ عهدٍ لم نعد نتذكّر الأيام فيه»، في مرفأ ملتبسٍ «يشبه ما تناقله الربابنة القدامى عن مرافئ تختفي في البحر أزماناً، لتطْلُع مرةً أخرى»، ثمّ مضوا فيها. والقصد أن يوجه القارئ نحو فكرة الارتحال الدائم، الذي تغذيه القطارات والحافلات الوفيرة في الكتاب، لكأنّ الحياة في العالم المعاصر إن ليست إلا رحلةً في قطارٍ سريعٍ موحشٍ. فالقطار يغدو استعارةً لنقدِ العالم المعاصر، حتّى ولو كانت القصيدة تسأل بـ «براءة»: «أين تمضي كلّ هذي القطارات؟».
والكلام عن التقنية يحيلنا فوراً إلى مقدّمة الكتاب (عن هذه المحاولة في النصّ الشعري)، حيثُ يكتب سعدي: «كتبتُ هذا النصّ، محاولةً، في القصيدة العربية غير التقليدية كما أراها، أي القصيدة الخارجة على اللعنة الثنائية الناشبة»، إذ يصف ما تضمّهما دفتا الكتاب بالنصّ الشعري، على رغم احتوائه الشعر والنثر ومسرحية وحيدة (سفينة الأشباح).
صراع ومفاضلة
وربما قصد سعدي بـ «الثنائية الناشبة» التصويب على المفاضلة بين الشعر الموزون (قصيدة التفعيلة) والشعر غير الموزون (قصيدة النثر)، باعتبار أن الصراع بين الخيارين أضحى إلى اللعنة أدنى، نظراً إلى تأثيره السلبي على الشعر الحديث. فمن جهة تمّ تضخيم دور الوزن في شعرية القصيدة، فإن حضر فيها عُدّ حتّى النظم شعراً، وإن غاب عنها عُدّ حتّى النثر شعراًً، على نحوٍ تمّ فيه اختصار الشّعر برمته إلى عنصرٍ وحيدٍ. ومن شأن أمرٍ مماثل أن يطرد الشّعر من الفنون، إذ إن الفنّ لا يقوم البتة على عنصر وحيد، و إلا بَطُلَ أن يكون فنّاً من أصله. ومن جهة أخرى، بدا النثرُ ضحية الصراع الشهير. لكن هذا الفنّ الرفيع، استطاع على مهلٍ أن يتألّق في الحداثة على أيدي الشعراء تحديداً لسببين : فهو أوّلاً شقيق الشعر الخفي، وثانياً صادفه حظٌ كريم، في أن يكون عدد الشعراء الذين يعملون في الصحافة (الجرائد والمجلات) أكثر من عدد الروائيين. فطبيعة عمل الشاعر القائمة على تخيّر اللفظ في القصيدة لبناء الاستعارة وتركيب المجاز وصقل التشبيه، تنعكس في دقّة المعنى ورهافة الوصف في النثر.
لكن يبدو أن سعدي لم يقصد التصويب على الصراع الشهير، إذ هو يختتم كتابه قائلاً: «انتهيتُ من تدوين هذه القصيدة الشاملة»، فهو يعدّ ما كتبه قصيدةً.
والظنّ أن ما يتيح جمع النصوص والقصائد بين دفتّي الكتاب، ليس حضور الوزن أو غيابه، بل هو السياق المحكم الذي يشدّها نحو معناها العامّ الذي يدور حول إعادة النظر في المسلّمات، ونقدها وإبداء الرأي الحرّ. فنصّ «يوميات روما» الذي يتناول فيه سعدي «مجموعة صغيرة من قصائد كتبها الشاعر الألماني غوته عن رحلته الإيطالية» (قصائد إروتيكية)، ينتمي إلى النثر صراحةً. لكن وروده في الكتاب يسمح لسعدي أن يرى في ديوان غوته تحرّراً وفتحاً للآفاق.
وبعيداً من «اللعنة الناشبة»، ثمة متعة خالصة في قراءة نص «هارلم حيث لا جاز» ومن بعده «تنويعٌ» التي آثر سعدي ألا يضع أي علامات للتنقيط، كي يتبختر الإيقاع من تلقائه: «ولا جاز في هارلم ولا جاز في دمي ولا جاز في الدنيا ولا جاز في التي ولا في اللّتيا».
وثمة متعة أخرى في قراءة سعدي – كما دائماً -، إذ هو يتقن انتشال الألفاظ القديمة (الصهد، الهاجرة، الفاختة…)، ويبرع حين يجلو عنها غبار القواميس، فتغدو دليلاً واضحاً على نجاحه في التصويب الذكي نحو مقولة «الانقطاع بين التراث والحداثة»، من دون افتعال أو تصنع، وبذا يظهر سعدي يوسف متجدداً متألقاً وممتعاً، ووارثاً حقيقياً لجمال الشعر العربي… وباقتدار.
عن الحياة
# ناقدة سورية





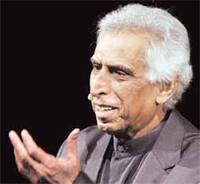




“فساد الأمكنة”.. تصدعات الحكمة، واستفحال المأساة
“الحالة الحرجة للمدعو ك” – فخّ “اليوميات” بين الحيلة الشكلية والغاية البنيوية
“كتاب النوم”.. تأملات كثيفة كالحُلم / محمود حسني