جبران خليل جبران – في عيد ميلاده ال 129
وأنا الآن إلى جانبكم
أغمضوا عيونكم
أنظروا حولكم
وستروني ..
( جبران خليل جبران )
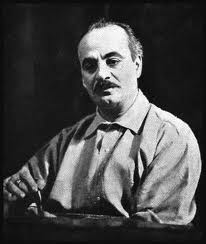 مرت علينا الذكرى التاسعة والعشرون بعد المائة لوفاة عبقري الأدب المهجري ” جبران خليل جبران ” بصمت كما كان رحيله ، لكنني وكعاشق لصاحب الناي الذي تغلغلت كلماته أركان السهل والجبل ، وتسلقت اشجار الأرز لم تفتني زيارته وهو ممسك بكتابه ” النبي ” ويجلس في غرفة مفتوحة من الطابق الثاني لمتحف الشمع الذي يقع عند مفترق الطريق المؤدي الى مغارة جعيتا الشهيرة بعد حوالي 12 كيلومترا من العاصمة بيروت .
مرت علينا الذكرى التاسعة والعشرون بعد المائة لوفاة عبقري الأدب المهجري ” جبران خليل جبران ” بصمت كما كان رحيله ، لكنني وكعاشق لصاحب الناي الذي تغلغلت كلماته أركان السهل والجبل ، وتسلقت اشجار الأرز لم تفتني زيارته وهو ممسك بكتابه ” النبي ” ويجلس في غرفة مفتوحة من الطابق الثاني لمتحف الشمع الذي يقع عند مفترق الطريق المؤدي الى مغارة جعيتا الشهيرة بعد حوالي 12 كيلومترا من العاصمة بيروت .
في هذه الدارة القديمة والانيقة بنفس الوقت أقام الاخوة معلوف متحفهم الشمعي لكبار الشخصيات الادبية والفنية والسياسية ليس مقصورا على لبنان فقط بل استضاف على أرضه نخبا أخرى من أنحاء العالم ، لكنني وأنا أطأ بقدمي سلالم ذلك القصر بعد أن علمت من المرشدة السياحية أن جبران ينتظرني في غرفة مكتبه ، انتابتني رعشة خفيفة أحسست بعدها أن نداء جبران لي رفع عني رهبة لقياه فتقدمت بخطى وئيدة نحوه حتى إذا ما وقفت أمامه سقط عني خوفي فالتقت عيناي بعينيه وشعرت بشيئ يتحرك فيه وسمعت كلماته :
– اقترب ايها المفتون بي ..
حاولت ان أمد يدي اليه ، لكنه أومأ لي برأسه مكتفيا هكذا بتحيتي وعاد ثانية قائلا :
– متى عرفتني ؟
قلت :
– بيني وبين معرفتك سنوات طويلة سبقت بياض شعري وانحناءة قامتي ، تعرفت عليك وأنا بعد صغير على القراءة ، ولما لامست كلمات شعرك شغاف قلبي أحببتك وحفظـــت منها :
عجـــبا أتوحشني وأنت إزائي
وضياء وجهك مالئي سودائي
لكنـه حـق وإن أبــــــت المنى
أنا تفرقــــــــــــــــنا لغير لقاء .
طأطأ جبران رأسه برهة ثم ما لبث ان نظر الىّ ثانية وتمتم بكلمات لم يسمعها غيري :
– ايمكنك ان تقرأ عليّ المزيد فالشاعر يحب ان يسمع قصيده من غيره حتى يكتشف فيه مواطن الجمال .
ذاك الهوى أضحى لقلبي مالكا
ولكل جانحــــــة بجسمي مالئا
فبمهجتي نـوران بركان جوى
وبظاهـري شخص تراه هادئا
وبعد ان انهيت قراءة هذه الابيات وجدته على حاله شاخصا بناظريه الى الارض ولمحت دمعة حيرى حاولت ان تختبئ لكنها سقطت اخيرا فلم اجد لها اثرا ، ثم نظر اليّ ثانية وقال :
هذه الابيات واخرى كثيرة تذكرني برحلتي الى أمريكا ، فقد غادرنا بيروت اليها عام 1885 بعد ان اشتد علينا الفقر ولم يكن أمامنا الا الهجرة بعد أن سمعنا ما سمعنا عن أمريكا ، فحاولت ان اكون رساما بعد أن شجعتني والدتي لكن سحر الكلمة تغلب على الالوان وهكذا تنزلت على فمي آيات من النثر والقصيد زادها حب تملك الروح فكانت تلك الابيات ترجيع لصداه ولي ايضا :
على رغم النوى أبقى قريبا
وليس بضائري بعد المكان
إذا ما فات عيني أن تراكم
ففي قلبي أراكم كل آن
– اعرف انها قيلت ل……
وقبل ان أكمل كلامي صاح بي :
– أرجوك دع الاسماء فاني لم أحاول ان أذكرها في كل ما قلته ، وسيبقى طيفها الجميل يحوم في حلي وترحالي أنا حييت وأنا مت .
علمت ان كلامي حول ” مي زيادة ” يؤلمه فأردت ان أغير الموضوع فانتقلت بالحديث الى مشواره الأدبي والفني وكيف كانت هي البداية ، اجاب :
– لايخفى عليك أن بداياتي كانت مع ” دمعة وابتسامة ” عام 1814 لكنها لم تكن سوى جمع لمقالات بالعربية وعددها 58 مقالة ، نشرت في المهجر وقد ترددت في نشرها لأن اسلوبها كان غير معروفا في الادب العربي ، فقد اتخذت تلك المقالات شكل قصيدة النثر كما تطلقون عليها الآن ، وفيها نفحات انسانية وضمت كذلك تأملات في الحياة والمحبة واوضاع بلادي ، وفي تلك الفترة شعرت بالحاجة الى الكتابة بالانكليزية فقرأت شكسبير وأعدت قراءة الكتاب المقدس مرات عديدة بنسخة ” كينغ جيمس ” وعكفت على قراءة الوان مختلفة من الادب الانكليزي لأن لغتي كانت محدودة ولأجله فقد عملت طويلا حتى أتقن لغة شكسبير دون أن اتخلى عن لغتي الأم العربية .
وفي هذه الاثناء شاركت في مجلة جديدة تدعى ” الفن السابع ” والتي كان ينشر فيها كُتاب مشهورون مثل ” جون دوس باسوس ” و ” برتراند رسل ” وقد اصبحت مشهورا في الاوساط النيويوركية ، حيث نشرت رسومي ونصوصي الاولى بالانكليزية فيها ، تلك كانت البداية .
– بعد ان عززت من مكانتك الادبية والفنية في أمريكا جاءك الروائي الفرنسي ” بيير لوتي ” وقدم لك نصيحة ؟
– نعم .. اذكرها .. عبر لي لوتي عن قرفه من صخب أمريكا وقال لي جملة لازالت عالقة في ذهني : أنقذ روحك وعد الى الشرق ، مكانك ليس هنا ..
– ولكن حسب معلوماتي ، لم تلتزم بكلامه وبقيت في ذلك الصخب حسب تعبير بيير لوتي .
– أجل ، فقد كنت بحاجة الى الانطلاق اكثر هناك وكانت عودتي تلح علىّ إلا انني جابهتها بالرفض ، كانت ثمة قوى خفية تتصارعني بالبقاء أو الرحيل وعندما أصرت الافكار على البقاء سافرت روحي وحيدة الى أرض الاجداد وها أنت تراني في بيروت ولا تراني ..
توقفنا تحن الاثنان برهة عن الكلام فقد كنت بحاجة الى تأمله اكثر حتى أراه قبل ان لا أراه ، كانت له ملامح أهل قريته ، وجه ملوح بالسمرة ، وأنف بارز ، وشارب اسود كثيف ، وحاجبان مقوسان ، وشعر معقوص قليلا ، وشفتان ممتلئتان ، وجبين عريض مهيب ، وعينان يقظتان تنمان عن ذكاء ، قصير القامة ذي ابتسامة مشرقة موحية ببراءة الاطفال ، حرك لايتوقف كأنه شعلة من اللهب ، لكنه ومع كل ذاك التوصيف كنت أراه حزينا ، محب للعزلة كما قرأت عنه ، فالوحدة عنده تعني صمت تقتلع كل الاغصان الميتة ، لكنه يجد لذة في العمل ، أنوف ، وبالغ الحساسية ، ولا يتسامح مع أي نقد ، مستقل وثائر بطبيعته ، يأبى الظلم بأي شكل ، كان يدخن كثيرا فقد كتب الى ” ميري ” صديقته الحميمة وخازنة أسراره : ( دخنت اكثر من عشرين سيكارة ، التدخين بالنسبة لي هو متعة وليس عادة مستبدة ، وليلا ، كي ابقى متنبها واستمر في عملي ) ، كان يتناول القهوة بشراهة ، ويعشق الحمامات الباردة ، إلا أن اسلوب الحياة إياه بدأ ينهك جسمه ويضفي عليه ملامح الكبر .
جبران أحس انه كلما امسك بالقلم أو الريشة يجد ان اصابعه لاتقوى على الامساك بهما فيتركهما برهة حتى اذا شعر بزوال ذلك الارتعاش عاد ثانية اليهما ، لأن مشروعه الذي بدأ به منذ سنوات طويلة لابد ان ينهيه .
كتاب ” النبي ” موضوع واسع يحتاج منه الغوص في فلسفات الأمم وتجلياتها ولذا راح يترقب وصول رجالات الفكر والفلسفة الى أمريكا للإلتقاء بهم والتحاور معهم لإغناء ذلك الموضوع ، فمر به شاعر الهند الاكبر وفيلسوفها ” رابندرات طاغور ” عام 1916 ، عوضا عن ” برتراند رسل ” الذي تعرف عليه سابقا ، ومع اقتراب الحرب العظمى الأولى من نهايتها استطاع جبران من كتابة مقاطع جديدة من النبي تتوائم وتلك المعرفة التي اكتسبها من شخوص فكرية لكنه في نفس الوقت انجز كتابه ” المجنون ” وتلك هي سُمات عبقريته ، هنا حاولت أن أخرج من ارشيف الذكريات التي امتلئت بها خزانة افكاري بعد ان شاهدته يلتفت اليّ ليكلمني لكنني سبقته بالكلام :
– سيدي .. لماذا كتبت المجنون بالذات ؟
– هذا الكتاب شكل منعطفا في مسيرة أعمالي ، فقد تميز بالبساطة ، واللهجة الساخرة والمرارة احيانا ، وليس فقط لأنه أول كتاب لي بالانكليزية بل لما فيه من تأمل وسمو روحي .
– لكنك جعلت منه مدخلا لأعمال فلسفية اخرى تناولتها فيما بعد خاصة في عمل كالمواكب مثلا ؟
– أجل .. ” المواكب ” ، كانت قصيدة طويلة نشرتها عام 1919 تألفت من مائتين وثلاثة أبيات ، فيها دعوة للتأمل كتبتها على شكل حوار فلسفي بصوتين يسخر أحدهما من القيم المصطنعة للحضارة ، والآخر يبدو اكثر تفاؤلا لذا تجده يغني أناشيدا للطبيعة ووحدة الوجود ، هذا الكتاب تميز بتعابيره البسيطة ، الصافية ، والتلقائية .
– أعمالك هذه هل هي محاولة منك لإخراج الأدب العربي في المهجر من شكله القديم والراكد ، أم انها تقليد كما عرفناه على يد كثير من أدباء عصرك آنذاك ؟
– هذا السؤال يعيدنا الى عام 1920 حينما اجتمع حشد من الأدباء السوريون واللبنانيون في نيويورك لاخراج الأدب العربي من ركوده ، وفيه قررنا تأسيس تنظيم يتمحور حول الحداثة التي بدأت تنتشر ايضا في واقع الأدب الغربي ، ويكرس لجمع الكُتاب وتوحيد جهودهم لخدمة الأدب العربي ، وانبثقت منه رابطة اسميناها ” الرابطة القلمية التي ضمت بين صفوفها ” إيليا أبو ماضي ” و ” ميخائيل نعيمة ” و ” عبد المسيح حداد ” وآخرون تعهدت الرابطة بنشر أعمال أعضائها وأعمال الكتاب العرب الآخرين ، وتشجيع تعريب أعمال الأدب العالمي ، وقد وصلت أصداء انبثاق هذه الرابطة الى عموم الوطن العربي ، فكانت هي اللبنة الأولى لأدب المهجر واستطاعت أن تقدم نماذج أدبية رائعة تلقفتها ذائقة القارئ العربي المتعطشة لهذا التجديد .
هنا ودعت جبران الذي حدجني بنظرة فهمت منها أنه سيلقاني مرة ثانية فهو لاينسى أحباؤه بسهولة .
جبران الذي كان يكلمني وكتاب النبي مازال ممسك به ، فأحببت ان يقرأ لي منه ، إلا اني شعرت كمن يهمس في أذني قائلا :
– عذرا .. سيدي .. المتحف سيقفل أبوابه ولم يبق أمامك سوى أن تودع اديبنا الكبير ، وقد يكون هنالك موعد ثان للقياه في زمن قادم غير هذا ، فجبران الذي ودعنا بروحه موجود في ظمائرنا وفكرنا وغيومه لازالت تمطرعلينا دررا من أدب رفيع وقصائد
أحمد فاضل
كاتب وناقد عراقي





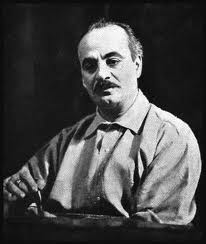




“فساد الأمكنة”.. تصدعات الحكمة، واستفحال المأساة
“الحالة الحرجة للمدعو ك” – فخّ “اليوميات” بين الحيلة الشكلية والغاية البنيوية
“كتاب النوم”.. تأملات كثيفة كالحُلم / محمود حسني